مساحة إعلانية
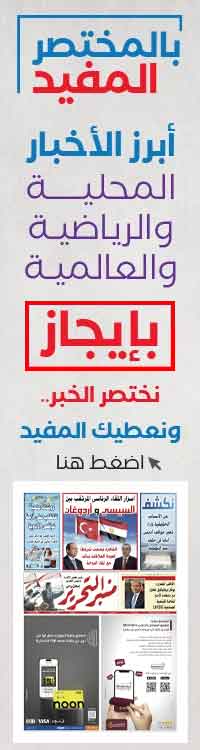


يُعَد ميدان (الست عزيزة) من أهم ميادين مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، لوجود واحد من أهم المقامات والأضرحة الأثرية في المحافظة، وهو مقام وضريح (الست عزيزة) التي ولدت في سنة (190ه)، عاشت السيدة (عزيزة) في أخميم واشتهرت بالزهد والصلاح والتقوى، حتى وافتها المنية عن سبعين عامًا سنة (260ه)، وقد نسب إليها أهل البلدة العديد من الفضائل والكرامات، والسيدة (عزيزة) هى ابنة الصوفي والعالم الزاهد (ذو النون المصري)، والذي يعتبر أول من غرس بذور التصوف بمعناه الاصطلاحي في مصر، ويصفه المتصوفة بالزاهد والعابد الأول، ولد أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المُلَقّب بذو النون المصري في سنة (179ه) في مدينة أخميم بسوهاج، من أب نوبي من موالي قريش على رواية محمد بن يوسف الكندي في كتابه (الموالي)، ونشأ في بيئة دينية وأسرة عُرفَت بالزهد والتقوى والعلم، وتميز عنهم بالتأمل والتفكر وكثرة الترحال، ويقال أنه سمع يومًا صياحًا وزفافًا فقال: ما هذا؟ قيل عٌرس. وسمع بجانبه بكاء وصياحًا، فقال: ما هذا؟ فقيل: فلان مات.
فقال: أُعطي هؤلاء فما شكروا، وأُبتلي هؤلاء فما صبروا.
وأقسم ألا يبيت بالبلد فخرج إلى (الفسطاط)، واتخذها سكنًا وموطنًا.
وهناك تعرف على (شقران المغربي) الرجل الزاهد الذي قال عنه الشعراني في كتابه (طبقات الصوفية) "عارفُ ظهر ضياؤه، وطاب ذكره وثناؤه، وكان ذا أحوال باهرة ومقامات فاخرة"، فتبدلت أفكاره إلى الزهد والتصوف وعلوم الباطن، فكان أول صوفي في تاريخ الإسلام يتكلم في المعرفة على أسس علمية منظمة، وهو من أهم أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري، بل يعتبره البعض رأس التصوف كما يقول إمام الصوفية أبو القاسم القشيري في كتابه (الرسالة القشيرية في علم التصوف):
(إنه أول من عرًف التوحيد بالمعني الصوفي وأول من وضع تعريفات للوجد والسماع والمقامات والأحوال)، ويقول عنه الجامي إنه (أول من استعمل رموز الصوفية فرارًا من اعتراض المعترضين).
لم يكن ذو النون المصري جانحًا في تصوفه بل كان معتدلًا وفقيهًا، وتحدث في مقالاته عن المعرفة الإلهية أكثر من حديثه عن الاتحاد والوصول، ومن أقواله: (إنه بمقدار ما يعرف العبد من ربه يكون إنكاره لنفسه، وتمام المعرفة بالله تمام إنكار الذات)، وكان كثير السفر والترحال يُعلم ويتعلم ويلتقي بمحبيه ومريديه، تنقل بين مصر ومكة والبصرة وبلاد الشام، وزار القدس وانطاكية وغيرها من البلاد، ولكثرة حديثه بالمصطلحات والألفاظ الصوفية مثل الأنس والوجد والسماع، والغيبة والوصال والتوبة والإخلاص، والتقوى والورع والتوكل والغفلة، أنكر عليه العلماء ذلك ورموه بالزندقة، فقال له أخوه: إنهم يقولون إنك زنديق.
فقال: وما لي سوى الإطراق والصمت حيلة.
وسعى بعضهم للوقيعة بينه وبين الخليفة المتوكل قائلين: (إنه أحدث علمًا لم يتكلم فيه الصحابة والسلف)، فاستقدمه الخليفة العباسي المتوكل إلى بغداد بغية عقابه، وكان ذو النون ثابتًا واثقًا من نفسه، وطلب منه الخليفة أن يسمعه شيئًا من قوله، ففعل وأصابت كلماته قلب الخليفة المتوكل، فأنس له قائلًا: (إن كان هؤلاء زنادقة، فمن على وجه الأرض مسلم) ورده إلى مصر معزّزًا مُكرّمًا.
فأبو الفيض لم يكن مجرد صوفي زاهد فقط، بل كان فقيهًا وعالمًا حافظًا للقرآن الكريم، وقد تتلمذ على يد مشايخ أجلاء في عصره مثل الإمام مالك بن أنس إمام المدينة المنورة، وكان من رواة (الموطأ)، والليث بن سعد في مصر، والفضيل بن عياض وابن لهيعة، وفاطمة النيسابورية التي التقى بها في العراق، وتبحر أيضًا في علوم الطب والكيمياء، وتعلم السريانية وكانت له محاولات لتفسير اللغة الهيروغلوفية وفك رموز البرديات في أخميم، ويذكر الدكتور (عكاشة الدالي) في أحد أبحاثه، "أن ذو النون المصري فك طلاسم الخطوط المصرية قبل الحملة الفرنسية بألف عام، يفهم معانيها وينقل ما فيها من أفكار للناس، وأنه كان يجيد اللغة القبطية وبعض من الديموطيقية والهيراطيقية والهيروغليفية، وله كتاب يتحدث عن تلك التجربة اسمه (حل الرموز وبري الأرقام في كشف علوم أصول لغات الأقلام)، ولذو النون المصري مؤلفات أخرى عديدة مثل كتاب المجريات، والعجائب، والركن الأكبر، وكتاب الثقة في الصنعة (في الكيمياء)، وكتاب أشعار في حجر الحكماء. ومن أقواله الخالده:
(توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة)، (من تذلل بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه الله بعز الانقطاع إليه)، (ألا إن حب الله عز وأمل، وحب غير الله خزي وخجل).
وتذكر الكتب العديد من المواقف النادرة والحكايات في حياة إمام الصوفية ذو النون المصري، عن توبته وتعاليمه، وكيفية تأديبه لتلاميذه، وعن الكرامات التي يرددها تابعيه ومريديه. وقد وافته المنية في الجيزة سنة (245ه – 859م)، ونقل جثمانه إلى مقابر أهل المعافر بالمقطم عن طريق النيل بسبب ازدحام الشوارع بالناس، ويقال إن الطيور قد رفرفت فوق جنازته حتى وصل قبره.
كانت ولا تزال مصر من قديم الأزل أرض خصبة للتصوف بمعناه العام، من تزكية للنفس وسمو للروح، وسلوك الطريق لمعرفة رب العباد، ومعناه الخاص بالانقطاع عن الدنيا وملذاتها، والتفرغ التام للعبادة والتأمل، فلا ضير إن اعتبرنا أن حياة الكهنة في معابد مصر القديمة هي ضرب من ضروب التصوف، وكذلك خلوة الرهبان في الأديرة، وعن التصوف في الثقافة الإسلامية فإننا نجد أقطاب الطرق الصوفية كالماء والهواء في ربوع مصر منذ بداية نشأت ذلك المنهج وحتى يومنا هذا، فلا تخلو قرية أو مدينة في مصر من أتباع الطرق الصوفية والتي يتجاوز عددها السبعة وسبعون طريقة تقريبا، وتتشابه جميعها في مذهبها وميثاقها وطريقتها الاحتفالية فجميعها منبثقة من بضعة طرق رئيسية لا تتجاوز السبعة تقريبا ومنها (الأحمدية أو البدوية نسبة لأحمد البدوي)، (الشاذلية نسبة لأبو الحسن الشاذلي)، (الرفاعية نسبة إلى الرفاعي)، (الدسوقية نسبة لإبراهيم الدسوقي)، (الجيلانية نسبة لعبد القادر الجيلاني)، (التيجانية نسبة لأبو العباس التيجاني)، (النقشبندية نسبة للنقشبندي) وطرق أخرى مثل الطريقة الجعفرية، والعزمية، والقادرية والبرهمية. ويوجد في مصر مقامات لثلاثة من الأئمة المؤسسين للطرق الصوفية وهم ( السيد أحمد البدوي، وإبراهيم الدسوقي، وأبو الحسن الشاذلي