مساحة إعلانية
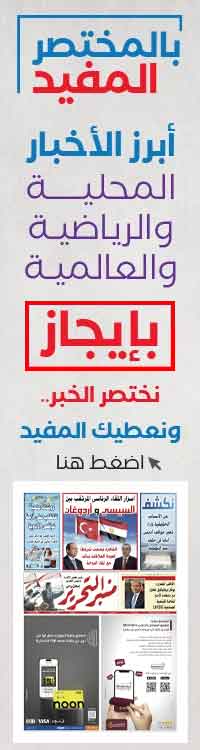


فارس رمضان
(قراءةٌ تحليليةٌ)
ترْتكزُ قراءتي للنصِ على خمسةِ عناصر جاءت على الترتيبِ التالي:
1- مقدمةٌ لا ينبغي إهمالها
2- العنوانُ، وظيفته ودلالته
3- تحليلُ خطابَ النص
4- تفكيكُ البناء
5- نهايةُ القصة

أولا: مقدمةٌ لا ينبغي إهمالها
لا شك أن النصَ، أي نص، ينبغي أن يحملَ على عاتقِه رسالةً، أو قيمةً يريدُ الكاتبُ رصدَها، وهذه الرسالةُ وتلك القيمة يؤسسُ لها الرهان، وتكون قابعةً طيلةَ الوقتِ خلفَ المفرداتِ التي يستخدمُها الكاتبُ ليبني بها نصَهُ، وتَتمثلُ في اللغةِ المعماريةِ التي تُحددُ فضاءاتِ النصِ وشخصياتِه وأماكنَهُ وحبكتَه. وعلينا –كقراءٍ واعين- أن نحاولَ خلخلةَ جدرانِ البناءِ المعماريّ للنص، المكونُ من حروفٍ وكلماتٍ بطبيعة الحال، ونظلُ نضربُ أُسسَهُ ودعائمَه بقوةٍ حتى ينهار، ونعيدُ ترتيبَ الكلماتِ وتحليلَ المعاني وتفكيكَ الرموز، ثم نشرعُ في تشييدِ البناء النصي من جديد، فتتكشفُ لنا ما بداخلِه من كنوزٍ دفينةٍ، ونتماهى معه حتى نصل إلى تمامِ المتعة.في رحلةِ استنطاقي لهذا النص البديع حاولتُ أن أبحثَ عن قراءةٍ تُرضي قناعاتي، قراءةٌ أتجنبُ فيها ليَّ عنقِ النصِ أو تحميلَ المفرداتِ ما لا تُطيقُه من معانٍ، فبحثتُ عن مفاتيحَ وإشاراتٍ تقودُني إلى إرساءاتٍ نصيةٍ أستطيعُ أن أتكئَ عليها وأقولُ في النهاية بقلبٍ مطمئنٍ: "ها أنا ذا قد وجدت أخيرًا قراءةً منطقيةً ترضيني!"
ثانيًا: العنوان
1- وظيفة العنوان
يُعدُّ العنوانُ نافذةَ النصِ، وله موقعٌ محددٌ يتفردُ به في فضاءِ القص، وهو من الضروراتِ الملحةِ والأركان الأساسيةِ التي لا يمكنُ الاستغناءَ عنها عند بناءِ النصوص. ويُعدُّ أيضًا مرآةٌ حقيقيةٌ تعكسُ مقصديةَ الكاتبِ، ويُعتَبرُ نصًا موازيًا للمتنِ، يمنحُه هويتَه ويحددُ مضمونَه، ويمتلكُ سلطةً وآليَّةً ذات طابعٍ تحريضيّ يمارسُه على المتلقي، ويهيئهُ نفسيًا لاقتحامِ النصِ والولوجِ إلى داخلِهِ والغوصُ في أعماقِه، ومن خلالِهِ يبني المتلقي توقعاتِه. وتتجلى أهميتُه فيما يُثيرُه من تساؤلاتٍ تدفعُنا إلى التماهي مع عوالمِ النصِ بحثًا عن إجاباتٍ مرضيةٍ نحاولُ إسقاطَها على العنوان، هذا بالإضافةِ إلى كونِه من الوسائلِ المعتبرةِ للكشفِ عن رهانِ النصِ والمساهمةِ في فكِّ ما قد يعتريه من غموض.
2- دلالةُ العنوانِ لغةً واصطلاحًا،
جاء في معجم المعاني الجامع أن كلمةُ "اِستغاثة" مأخوذةٌ من الفعلِ/ استغاثَ / استغاثَ بـــــ ، يستغيثُ، اسْتَغِثْ، استغاثةً، فهو مستغيثٌ، ومعناها: طلبُ الغوثِ والنصرةِ.والاسْتِغَاثَةُ (عند النحاة): نِداءُ من يُخَلِّصُ من شدةٍ، أَو يُعِينُ على دفعِ بليَّةٍ، ولأسلوبِ الاستغاثةِ ثلاثةُ أركانٍ: المستغاثُ به، المستغاثُ له، وأداةُ الاستغاثةِ والتي هي عادةً ما تكونُ حرفَ النداءِ (يا)، ويُقْرَن المستغاثُ به بلامٍ مفتوحةٍ، والمستغاثُ له بلامٍ مكسورةٍ، كقولِنا يا لَلهِ لِلمسلمين، ويا لَلجيشِ لِلشعبِ، وأحيانا نقول: يا ربًا لِلمظلومين، ويا قاضيًا لِلشاكين، بحذفِ لام (المستغاثُ به) المفتوحة، وأحيانا أخرى نقول: واغوثاه!
العنوان "استغاثة": نكرة، والنكرةُ تفيدُ عموم الأحداثِ لا تخصيصَها، وأتي في النصِ يحملُ صوتًا صارخًا.. هو صوتُ الكاتبِ بالطبع، جاء به على لسانِ الساردِ مخاطبًا به الجهاتِ المعنيةِ بالإنقاذ، لنجدةِ بطلِ القصةِ والتي هي أنثى بطبيعةِ الحال، قد تكون الحبيبةَ، وهذا ما لا أُرجِحُه، وقد تكون شخصيةً معنويةً تحملُ صفةَ الأنثى كحالٍ لكي يستقيمَ الخطابُ السردي، فيكون الخطابُ هنا (للنفسِ أو الذات، للهويةِ أو الحرية، للروحِ أو للوطنِ الأُم، وتؤثثُ لذلك المفرداتُ على مدارِ النصِ، ويمكنُ أن نلاحظَ روحَ الانسجامِ الموجودة بين العنوانِ (استغاثة) وبين متنِ النصِ وجملةِ الختامِ (تصرخينَ، ولا مجيب).
ثالثا: تحليل خطاب النص
بدأَ النصُ بجملةٍ مفصليةٍ احتوت على عناصرِ القصةِ الأساسيةِ لحظةَ بدايتها: الشخصية، وهي المعنيةُ بخطابِ السارد، الزمان (ليلًا)، المكان (فضاءٍ لا نهائي)، ويحيلُنا بها الساردُ إلى حالةٍ نادرةٍ من الطمأنينةِ كانت تعتري شخصيةَ القصةِ وهي تسبحُ في سماءٍ لا نهائية، فقال: تطيرينَ، تحلقينَ في الشموسِ ليلاً، كطائرٍ غيرِ مرئي يرفرفُ دون يأسٍ في فضاءٍ لا نهائي، ثم أعقبها بعبارةٍ تحذيرية: (لا تحُطي). وكأن الويلَ ينتظرُها إن هي حطَّتْ من عليائِها على الأرض.
الجملةُ الثانيةُ: تحيلُنا إلى عمليةِ نزولٍ، قد يكون هبوطًا اضطراريًا، صَاحَبَها جحيمٌ مفاجئ، وتُوحي من طرفٍ خفي إلى عمليةِ تحولٍ قصريّ لشخصيةِ القصةِ المعنيةِ بخطابِ الساردِ من كائنٍ سماويٍ علويٍ إلى كائنٍ طيني، فيقولُ الكاتبُ على لسانِ ساردِه: تسبحينَ في أمواجِ نارٍ، تُرتلينَ أناشيدَ من سفرٍ لم يكتبْ، وتقبضينَ بكفيكِ النحيلتين جمراتٍ مستعرة. ثم أعقبَها بعبارةٍ مطمئنةٍ: (لن تحترقي).
وقتئذ، وكأنَ العِقْدَ قد انفرطَ، تنزلقُ الشخصيةُ فوق منحنى يستمرُ في الهبوطِ على مدارِ النص، ويتصاعدُ معه مستوى ما تُلاقيه من أهوالٍ، غير أن الساردَ استطاع أن يبُثَ فيها الأملَ ويحُضَّها على الثباتِ ويُحفِزَها على الصبر، فيقولُ لها- بعباراتٍ مثَّلَتْ للنصِ مفاصلَ أساسية- يطمئنُها تارةً (لن تحترقي، الموتُ طور، البعثُ آتٍ)، ويحذرُها تارةً، فيقولُ لها: (لا تحطي، لا ترتدّي، لا تصمتي)، ويحفزُها تارةً أخرى بــ(قاومي، تجلدي)، ويستمرُ على هذه الوتيرة إلى أن يصلَ إلى ذروةِ الصراعِ فيضربُ ضربةَ الختامِ المدويةِ، التي قال فيها: (وحين تنظرينَ جنينًا يشقُ أحشاءَ أُمِه، ويَخرُجُ ليقتُلَها وينتحرُ تتأججين، وتُصغينَ إلى هولِ صمتي، فتصرخينَ، وتصرخينَ، وتصرخينَ. ولا مجيب.)
رابعا: تفكيك البناء
1-اللغة
اعتمدتُ في تفكيكِ النصِ على ما توحي به المفرداتُ من معانٍ، وعلى ما تحيلُ إليه الألفاظُ من دلالاتٍ، فقسَّمْتُ المفرداتِ إلى أفعالٍ وأسماءٍ وصفاتٍ وحروفِ عطفٍ وجر، ولم أعثرْ على حالٍ واحدٍ في النصِ، وهذا يحسبُ لبراعةِ الكاتبِ بالطبع، وكان اهتمامي بالأفعالِ دون غيرِها لأن حدث القص يعتمدُ على المفرداتِ بصفةٍ عامة، وعلى فعليةِ الجملِ على وجهِ الخصوص، وكانت المفرداتُ كالتالي:
- أفعال: وعددُها أربعةٌ وثلاثون فعلًا، وذلك بعد حذفِ تكرار الفعلِ (تصرخين)، الذي ما كان تكرارُه إلا لضرورةٍ فنيةٍ لا ينبغي أن نغفلَها لكي تستقيمَ الحبكةُ وينتظمُ الرهانُ نحو هدفِه المحددِ منذ البدايةِ إلى ضربةِ الختام. وصنفتُها في مجموعاتٍ؛ أفعالٌ مضارعةٌ مقرونةٌ بياء المخاطبة ومرفوعةٌ بثبوتِ النون: (تطيرينَ، تُحلقينَ، تسبحينَ، تُرتلينَ، تقبضينَ، تُداعبينَ، تتأملينَ، ترمقينَ، تنظرينَ، تتأججينَ، تُصغينَ، تصرخينَ)، وأخرى حُذفت نونُها إما لنصبٍ أو لجزم: (تحطي، تحترقي تصمتي، ترتدى)، وأخري كانت للغائب: (تبحثُ، تَحضرُ، يكتبُ، يُطلقُ، يرفرفُ، يستعرُ، يحرقُ، يخرجُ، يقتلُ، ينتحرُ، يشقُ، يسددُ)، وفعلان أمر، هما: (تجلدي، قاومي)، وفعلٌ ماضٍ واحدٌ، هو: (صرتِ) وفعلٌ واحدٌ له دلالةٌ مستقبلية، هو: (آتٍ)، وساهمَت الأفعالُ في خلقِ الديناميةِ اللازمةِ لتطورِ الأحداثِ والمضي بها قدمًا، والتعبيرُ عن الصراعِ بدقةٍ، بل وخلقُه، وتحريكُ الحبكةِ إلى الأمام.
- وهناك بالطبع أسماءٌ، وصفاتٌ وحروفُ جرٍ وعطفٍ: ووجودُها لم يكن مجانيًا، وتموضعُها أدى الغرضَ باقتدارٍ، وساهمت في خلقِ اللغةِ الشعريةِ التي ميزتْ النصَ.
- وبصفةٍ عامة، كانت اللغةُ شعريةً دالّة، مليئة بانزياحاتٍ على مستوى التركيبِ والدلالة، والألفاظُ سهلةٌ موحية، تشي بالمعنى ولا تصرحُ به، فتفتحُ بذلك مجالًا لمخيلةِ المتلقي لربطِ العلاقاتِ المشارِ إليها في النص. وتنوعت الجملُ ما بين الطولِ والقصرِ، فكانت قصيرةً موجزةً لكنها معبرةٌ، وكانت طويلةً لكنك لا تحتاجُ إلى الركضِ خلفها فتنكبُ على وجهِ المعنى وتتبعثرُ منك دلالاتُه. ورغم محدوديةِ الكلماتِ، التي بلغَ عددُها مئةً وسبعٍ وثلاثين كلمة، إلا أنها كانت تُحيلُ إلى عالمٍ شاسعٍ غني بالإيحاءاتِ والدلالاتِ والمعاني، وناقلةٌ للمعنى المراد.
2- السرد
جاءت البنيةُ السرديةُ للنصِ على هيئةِ (مونولوج داخلي)، أو هكذا أتصور، استخدمَ الكاتبُ في بنائِه الجملَ الإحالية، كما اختارَ الألفاظَ بدقةٍ ورتبَها بعنايةٍ، فجاء السردُ ساحرًا بموسيقاه الداخلية، وبات من يتلقاهُ يستمتعُ برنينٍ الحرفِ وينتشي من جمالِ الإيقاع، ولم يمنحْ السّاردُ بطلَ الحكايةِ اسمًا أو يميزْهُ بصفةٍ جسديةٍ في سرديتِه، ربما ليجعلَه رمزًا خالدًا لشخصٍ ما أو شيءٍ ما. وكانت النهايةُ سرديةً كما جاءت بدايتُها، وما بينهما ارهاصاتٌ، ورحلةُ معاناةٍ سببها خضوعُ الشخصيةِ لضغوطٍ نفسيةٍ ملحةٍ مارسها عليها الساردُ في محاولاتِه المضنيةِ لكي يُثنيها عن قرارِها بالهبوط؛ (لا تحطي).
3- تقنياتُ الكتابةِ المستخدمة
- التناقضُ/ التضادية:
هي أداةٌ من أدواتِ الكتابةِ الأدبيةِ المعتبرة التي يمكنُ استخدامَها في خلقِ اللغةِ المجازية، وفي ابتكارِ الصورِ الجماليةِ الموحية، واللازمة لتهيئةِ الأجواءِ المناسبةِ عند كتابةِ قصةٍ مثيرة، ويلعبُ التناقضُ دورًا حاسمًا في خلقِ التوترِ الدرامي اللازمِ داخل النص، ويُشكِكُ في النوايا الحقيقية لشخصياتِ القصة، ويُبرزُ ما يحيقُ بها من مخاطر، مما يبثُ في نفسِ القارئِ شعورًا بعدمِ الارتياح، ويُجبرُه على التشكيكِ في سلامةِ البيئةِ النفسيةِ والماديةِ المحيطةِ بالشخصيةِ الافتراضيةِ التي يؤسسُ لها الكاتبُ على مدارِ النص، فنجدهُ قد استخدمَ (الشموسِ ليلاً، أمواجِ نارٍ، أزيزَ الصمتِ، بواباتٍ جدارية، أسرابَ السرابِ، أنشودةٌ خرساء، تابوتٍ من رفاتِ قتلى، رمادًا يستعرُ فى جوفِ ماء، وتُصغينَ إلى هولِ صمتي) كتعبيراتٍ تأسيسيةٍ لأداةِ التناقضِ المستخدمة. وهذا التناقضُ أو التضادُ خلقَ نوعًا من ثنائيةِ الدلالةِ أدّتْ إلى تعدُّدِ القراءاتِ، وأنتجتْ عالما سرديًا مكتظًا بالمفارقات.
كما أنه توجد تعبيراتٌ متشابهةٌ في التركيبِ متعددةٌ في الدلالة، مثل: (طائرٍ غير مرئي، فضاءٍ لا نهائي، سفرٍ لم يكتب) وأخرى تحملُ دلالةً وظيفيةً استعاريةً متماثلة، مثل: (تسبحينَ في أمواجِ نارٍ، تداعبينَ أزيزَ الصمتِ عبر بواباتٍ جداريةٍ، تتأملينَ أسرابَ السرابِ، وأنشودةٌ خرساء تبحثُ لنفسِها عن أصداء، جثةٌ في تابوتٍ من رفاتِ قتلى، رمادًا يستعرُ فى جوفِ ماء، وتصغين إلى هولِ صمتي)
- توظيفُ العناصرِ الأساسيةِ للحياةِ، أو أصلِ الأشياءِ كما قالَ عنها العالمُ والشاعرُ والطبيبُ اليوناني (ايمبيدوكليس)، وذلك لخلقِ أجواءٍ من الغرائبيةِ تخدمُ رهانَ النصِ وتُبرِزُ أسلوبَ الكاتبِ الذي يتميزُ به، وهي: (الماءُ، والترابُ، والنارُ، والهواء)..فجاء عنصرُ النارِ صريحًا في (تسبحين في أمواجِ نارٍ)، وهناك من الألفاظِ ما يُدلِّلُ عليه، فنجده في (جمراتٍ مستعرة، يستعر، يحرق، وتتأججين).
ولم يظهر الهواءُ بلفظِه الصريح، غير أن هناك من الألفاظِ ما كان حاضرًا بقوةٍ ليُدلَّل عليه على مدارِ النص، مثل: (تطيرينَ، تحلقينَ، يُرفرفُ، طائر، فضاء)، وقد اجتمعت في فقرةٍ واحدةٍ قالَ فيها الساردُ: تطيرين، تحلقين في الشموسِ ليلاً، كطائرٍ غير مرئي يرفرفُ دون يأسٍ في فضاءٍ لا نهائي. وجاء الماءُ بلفظِه الصريحِ في (يستعرُ فى جوفِ ماء) وفي (هديل المياه)، وفي ألفاظٍ أخرى دالة كـــ(تسبحين، والغرقى، وأمواج). ولم أعثر للترابِ إلا على كلمةٍ واحدةٍ، هي (رمادًا)، في (وترمقين رمادًا)، ثم جمعَ الكاتبُ، ببراعةٍ، هذين العنصرين -الماءُ والترابُ أقصدُ- في جملةٍ مقتضبةٍ ذاتَ دلالةٍ قويةٍ وموحيةٍ، وهي: (وترمقينَ رمادًا يستعرُ فى جوفِ ماءٍ)، فمنهما خلقَ اللهُ كلَ شيءٍ حي، ثم أتبعها بـ(جنينًا يشقُ أحشاءَ أُمِه) لتأكيدِ معنى الخلقِ والإحياء.
- التكثبف
استخدمَ الكاتبُ الصياغةَ الدراميةَ السريعةَ، واستعانَ بالرموزِ والصورِ والتشبيهاتِ والاستعاراتِ والكناياتِ، وتعمدَ التكثيفَ غير المخل، والايجاز الذي هو ضد الإطالةِ والإسهابِ والثرثرة، فانتهكَ بذلك السياجَ الفاصلَ بين الواقعِ والمتخيلِ ونقلَ اللغةَ من مستواها الإبلاغي والإخباري إلى مستواها العاطفي مما أضفى على النصِ الشعريةَ والحيوية.
خامسا: نهاية القصة
تكمنُ نهايةُ القصةِ في الجملةِ السرديةِ الأخيرةِ التي كانت رائعةً في رأيي، ومثلتْ عتبةً منطقيةً للخروج، فقال الكاتب: (وحين تنظرين جنينًا يشقُ أحشاءَ أُمِه، ويخرجُ ليقتلَها وينتحرُ تتأججين، وتصغين إلى هولِ صمتي، فتصرخين، وتصرخين، وتصرخين. ولا مجيب.) لتتعانق لحظةُ الإفلاتِ من رحمِ النصِ مع التحذيرِ في بدايةِ المتنِ (لا تحُطي)، ولتنسجم مع العنوانِ (استغاثة)، وهنا تتجلى روحُ الهندسةِ المعماريةِ لنصٍ فارق.
وخـتـامًا
استمتعتُ بجمالِ الحكي ومهارةِ القصِ وأسلوبِ السرد، في نصٍ من النصوصِ البديعة قامَ بهندستِه خبيرٌ متمرسٌ في فنِ السرد، يعرفُ كيف يستدرجُ المتلقي إلى هدفٍ واضحٍ ومحددٍ أسّسَ له منذُ العتبةِ الأولى وحتى ضربةَ الختام، وليس هذا بغريبٍ على أستاذي الكبير/ محمود قنديل، الذي أفتخرُ دائمًا بأنه أحد أساتذتي القدامى.. ولا يزال.
قصة استغاثة للروائى والقاص محمود قنديل
تطيرين، تحلقينَ في الشموسِ ليلاً، كطائرٍ غير مرئي يرفرفُ دون يأسٍ في فضاءٍ لا نهائي.
- لا تحُطي..
تسبحينَ في أمواجِ نارٍ، ترتلينَ أناشيدَ من سفرٍ لم يُكتب، وتقبضينَ بكفيكِ النحيلتين جمراتٍ مستعرة.
- لن تحترقي..
تداعبينَ أزيزَ الصمتِ عبر بواباتٍ جدارية، وتتأملينَ أسرابَ السرابِ الحائمةِ حول قبابٍ محطمة.
- لا ترتدى..
كرةٌ صرتِ في قدمِ لاعبٍ يسددُها في الشباكِ هدفًا، وصفارةٌ في فيهِ حاكمٍ يُطلِقُها –بغير حقٍ– في ساحةِ الملعب.
- قاومي..
وأنشودةٌ خرساءٌ تبحثُ لنفسِها عن أصداءٍ، أو أذنٍ صاغية.
- لا تصمتي..
ونفسٌ تحضرُ في غمراتِ موتٍ..
- الموتُ طور..
وجثةٌ مسجاةٌ فى تابوتٍ من رفاتِ قتلى..
- البعثُ آتٍ..
وترمقينَ رمادًا يستعرُ فى جوفِ ماءٍ، يحرقُ الغرقى، وأشرعةُ المراكبِ، وهديلُ المياه.
- تجلدي..
وحينَ تنظرينَ جنينًا يشقُ أحشاءَ أُمه، ويخرجُ ليقتلَها وينتحرُ تتأججين، وتُصغينَ إلى هولِ صمتي، فتصرخينَ، وتصرخينَ، وتصرخينَ. ولا مُجيب.