مساحة إعلانية
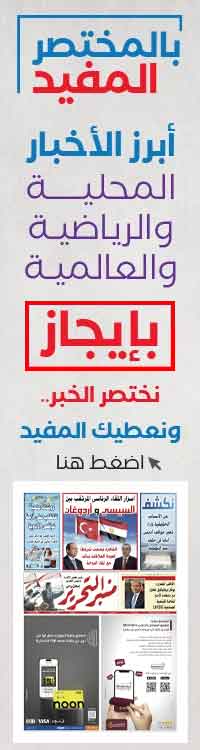


يوسف كمال-عبقرية السرد الهجين
بقلم : دسوقي الخطارى

مما لابد منه تضمين هذه السطور اعترافا صريحا مني شخصيا وشهادة حق كان لابد أن تقال، ذلك أنني في الثلاثين من ديسمبر عام 2014م أي منذ عشر سنوات مضت نشرت لي جريدة (منبر التحرير الغراء) تحقيقا صحفيا تحت عنوان “يوسف كمال الأمير المفتري عليه” ذلك الرجل الفنان والأديب الذي رفض أن يجلسه الانجليز علي عرش مصر، في حين قبل النحاس أن يفرضوه علي الملك والشعب، ليس عيبا أن أخبركم أن تلك المعلومات كانت غاية المتاح آنذاك لتقديم العون لمن قرأوا عنه أو تناولوا سيرته بالبحث أو الدراسة مما حدا بي أن أواسي نفسي بترديد ما نظم الشاعر السوري نزار قباني : ( فإذا لم استطع إيقاف / جيش الروم أو زحف التتار / وإذا لم أستطع قتل الوحش / فحسبي أنني أحدثت ثقبا في الجدار ) أما الآن وبعد قراءتي المتأنية للسيرة الروائية “يوسف كمال في رواية أخرى” للروائية المتميزة “مني الشيمى” أعترف أن ما كتبته ما كان إلا قشورا أو غيضا من فيض أما هي فقد أفاضت وأجادت أيما إجادة، وإنني أبدي جم إعجابي برواية رائعة مكتملة الأوجه و الأركان، لغة جزلة وعرضا فريدا متميزا يدفعني للقول بانها لم تدع لدارس أو ناقد خطأ أو ثغرة يمكناه من ذمها أو نقدها نقدا هداما ، وعودة إلي السيرة الروائية فهي آخر ما صدر للروائية المصرية ابنة محافظة قنا، أصدرت ثلاث مجموعات قصصية و خمس روايات و سلسلة كتب وثائقية للأطفال عن مصر القديمة، حصلت علي العديد من الجوائز، منها جائزة دبي عن مجموعتها “ من خرم إبرة “، وجائزة الشارقة عن مجموعة “وإذا انهمر الضوء”، ثم جائزة ساويرس للرواية – فرع كبار الكتاب – عن رواية “ بحجم حبة عنب “ وأخيرا وليس آخرا حصولها علي جائزة كتارا عن رواية “وطن الجيب الخلفي” أما السيرة التي نحن بصدد الحديث عنها فقد صدرت عن دار الشروق في حوالي ثلاثمائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط، اشتملت بين دفتيها علي أحداث وأحاديث والشخصية المروية، وعن أماكن وشوارع ونواد لم يكن بعضنا ليعرفها لولا الجهد الجهيد الذي بذلته الكاتبة بعرض نوع من أصعب أنواع الأدب بشكل أعم وأشمل، استقينا بعرض فقراته من مقال نشر بمجلة “ نذوي “ عدد أبريل 1989م هو (السيرة الروائية ) الذي يعتبره النقاد ابداعا مهجنا و مزيجا من سردين معروفين للسيرة والرواية، وحين نقول هجينا فإننا لا نقصد بالتهجين معني سلبيا، إنما التركيب الذي يستمد عناصره من مرجعيات معروفة وإعادة صياغتها وفق قواعد مغايرة ، أجبرت الكاتبة علي الاعتراف بأنها “ قبل بضعة أشهر كنت أدور في متاهة، وأفكر في إيقاف البحث عن الأمير يوسف كمال، لكن الأمر انفرج فجأة بعثوري علي مقالة طويلة عنه لكاتبة اسمها ليون سترازيك منشورة علي موقع بيرسي مجازين “ وتكمل الكاتبة رحلة بحثها عن بطلها التي دامت: “ثلاث سنوات من البحث عشرات الكتب ومئات من فناجين القهوة جمعت الكثير عنه، من ثنايا التاريخ، لكن أشياء تبقت جعلت بعض المعلومات غير منطقية أحيانا، متناقضة في أحيان أخرى، ظللت بحاجة إلي حلقات وصل تخلق مما جمعته حياة” وفي السيرة الروائية يدمج الخطاب بين الروائي والراوي فيصبحان كيانا واحدا، فهما مكونان متلازمان لعلاقة جديدة هي السيرة الروائية ولا يفارق الراوي مرويه، لا يجافيه ولا يتنكر له، إنما يتماهي معه، يصوغه ويعيد انتاجه طبقا لشروط مختلفة عن شروط السيرة والرواية، وهنا تصطحبنا الكاتبة لاسترجاع المعلومات التي تتمحور حول ملابسات الحادث الذي نتج عنه هذا الكم الهائل من العداء غير مسار ولاية العهد إبان حكم سعيد من أحمد رفعت إلي اسماعيل، الذي كان يفضله عمه سعيد علي أحمد رفعت ابن أخيه الأكبر سنا، ثم قيام اسماعيل بعد توليه الحكم بتهميش الأمراء من فرع أحمد و التضييق عليهم، وبحرفية فائقة تجعل مني الشيمي قارئها يتبعها – دون أن يدري – لتطلعه علي أدق التفاصيل المتعلقة باغتيال جد بطل روايتها أحمد رفعت أثناء عودته من الاسكندرية عقب الانتهاء من الاحتفال بليلة عيد الفطر، في ظهيرة يوم عودتهم إلي القاهرة، وكذلك الكيفية التي أعلن بها عن وفاته و عن سقوط العربة التي كانت تقله في الماء، وغرقه، ثم تستمر في تخيلها لحالة أسرة الفقيد في القصر العالي، وقت عودة اسماعيل ليخبر الجميع بلا أي مقدمات، ولا تمهيد بوفاة أخيه قائلا : “غرق أخي رفعت”
والسيرة الروائية هي نوع من السرد الكثيف الذي يتقابل فيه الراوي والروائي و يندرجان معا في تداخل مستمر، ولا نهائي يكون الروائي مصدرا لتخيلات الراوي، توفر هذه الممارسة الابداعية حرية غير محدودة في تغليب التجربة الشخصية للروائي، يشرح ويعاد تركيب الكيان الجسدي والنفسي والذهني للروائي، وتشحن التجربة الذاتية بالتدخل، ويبدو ذلك واضحا في معايشة الكاتبة معايشة كاملة مكتملة لكل تفصيلة أو جزئية ولو غير مفيدة أو نافعة في حياة بطل روايتها، ولكي نقترب أكثر تخبرنا بأنها “حاولت تحليل شخصية بطلى، ولم أنج بالتوازي من محاولة رد معاناتي الشخصية إلي واحدة مما سبق أو إليها جميعا، ربما عاني من فقدان التعلق الآمن في ظل حالة انسحاب ابيه، منعه من اختبار نفسه علي الساحة السياسية جعله لا يري ما منح من امتيازات أخري .... و أعتبر هذا المنع انتهاكا صارخا لحدوده، ربما نمت نرجسيته وقتذاك ، هذا وتوفر هذه الممارسة الإبداعية حرية غير محدودة في تغليب التجربة الشخصية للروائي وإعادة صياغة الوقائع واحتمالاتها وكل وجوهها دون خوف من الوصف المحايد و البارد للتجربة والانقطاع التخييلي عنها، وقد منحت هذه الحرية الكاتبة قدرة فائقة في صياغة الوقائع والأحداث بدقة متناهية، دون تحفظ أو خوف، كما يلاحظ أنها قد أبدعت أيما ابداع في تصوير بعض المشاهد التي اتسمت بالحساسية وتضمنتها فصول الرواية، رأت أن تترك اكتشافها والتعرف عليها للقارئ، مع منحه المساحة الكافية لتخيل ما بعد الحدث “جاءت كلفتير إلي أمه لاهثة التقطت أنفاسها وشرحت: “يا مولاتي عادل ابن عياد يقول إنه رأي أميرنا وسمعه مع وليم تريس مرة، وماير مرة و الكنجاري مرات، الخيم التي نصبوها في الهند لا تستر”، “شهران ونصف الشهر منذ عاد ابن عياد، سرت الفضيحة إلي القصور، ربما وصلت إلي الخديوي وهو يقضي أجازته في اسطنبول” مما يعني أن الكاتبة تتعمد التمهيد في حياء لاطلاع القارئ علي مثلية بطلها في عرض مشهد لاحق قد يكون أشد حساسية وأكثر إثارة، وبشكل من الأشكال فإن السيرة الروائية هي سرد ذاتي مباشر حتي لو استعان الراوي بالصيغ الموضوعية باستمرار خرق لتجربة الروائي الذاتية، ولا نكون مخطئين إذا ظننا أن خرقا أو أكثر قد تخلل الرواية في مواضع عدة كشفت بصورة مقصودة أو غير مقصودة بعض خصوصيات الروائية مثل “عدت إلي شارع بين السرايات تتبعثر ذكرياتي في أركان هذا الشارع، لم أكن قد تجاوزت الثانية عشر عندما بطحت نفسي بحجر كنت ألقيه علي سباطات حب العزيز والدوم المتدلية من الأشجار العالية فسقط علي رأسي من دون أن أصيب الهدف، وهناك تلقيت قبلتي الأولي من الحبيب الأول، قبلة خاطفة وسريعة، لكن أثرها لا يزال يرجفنى” و يمارس الاغواء فعله دون مواربة في نوع من الكشف الداخلي الجريء النادر وقد لوحظ ذلك في العرض الهام الذي حدا بالكاتبة أن تكشف عنه وعن غيره من أحداث قد لا يعلمها كثيرون كحادثة العوامات الراسية علي النيل” عقب مداهمة البوليس لها بعد الشكوي من أنها أوكار للرذيلة، في احداها وجدوا كريمة يحيي ابراهيم باشا القانوني الشهير في أحضان وزير الأوقاف اسماعيل صدقي” وإن صيغ الوعظ و الاستعلاء و النبذ والاستبعاد والخفض لا تجد لها مستندات تمنحها الشرعية ولا تتوفر إمكانية لأي شيء سوي الذات، وما يمر عبر منظورها، إن كل شيء يستمد أهميته و شرعيته الفنية بمقدار يقرره السرد الذي يتمركز حول شخصية واحدة للروائي الذي يصبح محورا مركزيا في النص، لم يكن بالرواية مجال لوعظ أو نصح أو نبذ أو استبعاد إلا وكان له ما يبرره، ويعضد موقفه، ويمنحه من الشرعية ما يجعله هاما، بل ضروريا في السرد و في رصد الأحداث، ولم يكن قط عبئا علي تسلسلها أو عائقا يمنعه من سيرها في انسيابية أو يؤثر سلبا علي منطقيتها، كما أنه علي الرغم من اتساع مساحة الوصف نراها لم تخل مطلقا بمعايير مطابقة الأحداث بأماكن حدوثها، سواء كتاريخ رسمي أو تاريخ مواز ونري ذلك في اعتراف بطل الرواية بانتصار خصمه “انتصر فؤاد وجلس علي الكرسي، قالت أمي انس هذا الثأر و أصرت علي الذهاب إلي جشم آفت”و أيضا: “اختير لأنه أحد أبناء اسماعيل، الكرسي من حقه بالوراثة، وتبرع مقابل التعديل بثلاثة آلاف جنيه للقوات الانجليزية من الخزينة “ وكذلك: “في 18 أبريل 1936 م مات فؤاد فاجأة، لا يمنحك موت خصمك المنتصر إلا الأحاسيس غير المفهومة، فرحت فيما إحساسي بالانكسار ظل يتضاعف آلاف المرات” ويقتضي الحديث عن السيرة الروائية الاشارة إلي أهمية التجربة الذاتية المستعادة والمصاغة صوغا فنيا مخصوصا يناسب متطلبات السرد والتخيل ومقتضياتهما، ذلك أن المادة التي يفترض أن تكون حقيقية و أصلية لا يمكن أن تحتفظ بذلك ما أن تصبح موضوعا للسرد، وإلا يعاد انتاجها طبقا لشروط تكونها قبل أن تندرج في سياق التشكيل الفني وعليه لا يمكن الحديث أبدا عن مطابقة حرفية ومباشرة بين الوقائع التاريخية المتصلة بسيرة المؤلف الذاتية والوقائع الفنية المتصلة بسيرة الشخصية الرئيسية في النص فالوسيط وهو السرد هنا يعيد ترتيب العلاقة بما يتوافق مع العالم الفني الجديد، وأن استعادة تاريخ حياة ما تخضع في الغالب لشروط زمن الاستعادة ووعي المستعيد ووجهة نظره ومستلزمات التعبير عن ذلك أكثر مما تخضع لشروط المسار التاريخي الحقيقي لتك الحياة، وذلك يفضي إلي التأكيد علي أن أمر المطابقة الكاملة بين الوقائع التاريخية والوقائع النصية في السيرة الروائية مستبعد ولا يفضي إلي نتيجة مفيدة لكل من التاريخ و السيرة والرواية، فرصد الصراع الدائم بين أمراء الأسرة العلوية والحقد والحسد والضغائن المنتشرة بينهم وأيضا الاستعراض الهائل والدقيق لأفراد الأسرة العلوية، الأميرات والأمراء والمستولدات والجواري و المعتوقات، الفساد السياسي والأخلاقي وفضح بعض الساسة المصريين سواء قبل ثورة يوليو أو بعدها، محاولات الأمراء استرضاء الشعب المصري، الأسرار التي كان الخدم والجواري يخفونها حتي عن أنفسهم خشية التنكيل بهم، الاسراف والصرف ببذخ علي المجون والنذوات الشخصية ورحلات الصيد، الوصف الدقيق لأحياء وشوارع القاهرة الخديوية، وكذلك القصور والسرايا والأماكن التي شهد أحداث الرواية سواء احتفظت بأسمائها القديمة أو تبدلت بأسماء أخري حديثة والتطرق للأحداث أو المناسبات التي تغيرت فيها اسماء هذه الأماكن. الرواية بشكل عام عالم متكامل لا يوجد بها ثمة شيء يعيبها أو مثلبا يشينها، اللهم إلا خطآن مطبعيان الأول في منتصف الصفحة 151 في لفظة (نقل ) وصحيحها (تقل) و الثاني في السطر قبل الأخير من الصفحة رقم (292) عند لفظة (دعوة) وصحيحها (دعوى) نأمل أن يتم تداركهما عند طباعة الرواية مرات لاحقة، ومما لا شك فيه أن الروائية المتميزة مني الشيمي استطاعت ببراعتها المعهودة والمشهود لها بها أن تسطر لنا أبدع ما يكون عن حقبة من التاريخ الموازي لتاريخ الأسرة العلوية، وأطلعتنا بعد البحث المضني علي حقائق لم يكن البعض يدركها من قبل.
