مساحة إعلانية
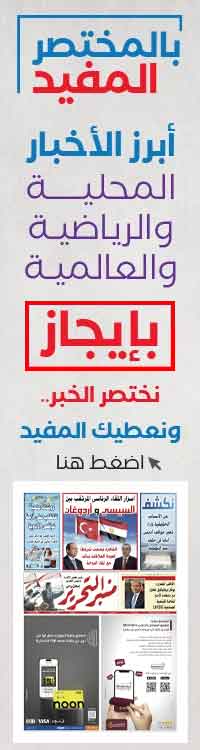


لقد كرم الله بني آدم على سائر الكائنات بنعمة العقل؛ الذي به يدركون، ويتذكرون، ويفكرون، ويقيمون. وهذه العمليات العقلية لا تعمل منفردة، بل تعمل كمنظومة في اتساق تام، فمثلاً الذاكرة تعتمد على الإدراك وكلاهما ضروري لعملية التفكير، وعندما يحدث الفصل بين هذه العمليات يكون بغرض الدراسة والتوضيح كما في موضوعنا الحالي عن "الذاكرة البشرية".
ويظهر الدور الحيوي للذاكرة في مختلف مجالات السلوك الإنساني، وهي تعمل بسرعة وبطريقة آلية، لدرجة أن قليلاً من الناس هم الذين يلاحظون وجودها في كل مجال، فهي تنشط أثناء القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، وحل المشكلات، حتى الأنشطة غير العقلية مثل: تناول الطعام وغسل الوجه وارتداء الملابس تعتمد أيضاً على الذاكرة، وفي الواقع فإن كل ما يفعله الناس تقريباً يعتمد على الذاكرة.
ويقصد بالذاكرة: مدى إمكانية استيعاب الشخص للمعلومات والأفكار والخبرات والأحداث التي مرت به، وإمكانية استعادتها في المواقف التي تتطلب منه ذلك. ولذا تعتبر ذاكرة الفرد إحدى قدراته الخاصة الأساسية التي تحدد بشكل كبير مدى كفاءته في كثير مما يقوم به من نشاط.
ويمكن معرفة عمل الذاكرة من خلال فهم المراحل الثلاث الأساسية التي تمر بها، وهي:
- مرحلة التحويل الشفري.
- مرحلة التخزين.
- مرحلة الاسترجاع.
أولاً: مرحلة التحويل الشفري:
إن البيئة التي تحيط بالإنسان تنطوي عادة على أحداث ومثيرات، ولا يستطيع الفرد التعامل معها جميعاً، إما بسبب الافتقار إلى الأجهزة الحسية اللازمة لاستقبال بعض هذه المثيرات، مثل الأشعة فوق البنفسية، أو تحت الحمراء، وإما بسبب عدم الرغبة، والانتباه إليها.
وقدرة الفرد على تركيز الانتباه نحو بعض المثيرات البيئية دون الأخرى تشكل أمراً هاماً في محصلة التحويل الشفري للمعلومات؛ لأنه لا يستطـيع أن يعالج إلا كمية محدودة من المعلومات في وقت واحد. كما أن الخصائص الفيزيائية للمثيرات "كاللون، والحجم، والشكل، والحركة" تؤدي دوراً مهماً في توجيه الانتباه إليها، وبالتالي تشفيرها.
وبعد الانتباه الانتقائي للمعلومات ، تبدأ عملية التحويل الشفري، وفي هذه العملية تتحول المعلومات من حالتها الطبيعية التي تكون عليها حينما تعرض على الفرد إلى مجموعة صور أو رموز، أي تتحول إلى شفرة لها مدلول خاص يتصل بهذه المعلومات، ومن نماذج شفرة الذاكرة ما يلي:
أ - الشفرة البصرية: حيث تمثل المعلومة بواسطة مظهرها البصري الدال عليها.
ب- الشفرة السمعية: حيث تمثل المعلومة بواسطة مظهرها السمعي الدال عليها.
جـ- الشفرة اللمسية: حيث تمثل المعلومة بواسطة خاصية اللمس الدال عليها.
د – شفرة دلالة اللفظ: حيث تمثل المعلومة بواسطة المعنى الدال عليها.
وبمجرد تشفير المعلومة تتلقاها أعضاء الحسّ تمهيداً لخزنها.
ثانياً: مرحلة التخزين (الحفظ):
في هذه المرحلة تتم عملية اختزان المعلومات التي تحول من المرحلة السابقة في الذاكرة، وتظل هذه المعلومات لحين الحاجة إليها.
ويوجد ثلاث أنظمة لتخزين المعلومات بالذاكرة هي:
1- نظام تخزين المعلومات الحسي:
يتم هذا النوع من التخزين داخل أعضاء الحس أثناء تلقيها للمعلومات التي تم تشفيرها، ولذلك يسمى هذا النظام بالذاكرة الحسية أو الخزن الحسي، وهذه المعلومات التي تحفظ في الذاكرة الحسية تشبه الصورة التي تظل في مخيتلك بعد النظر إليها. وهذه المعلومات تختفي في أقل من الثانية إلا إذا تم نقلها فوراً إلى نظام آخر للذاكرة وهو نظام الذاكرة ذو الأجل القصير. ولعل هذه الذاكرة هي التي تفسر إدراكنا للصورة المتحركة التي هي أصلاً عبارة عن سلسلة متتالية من الصور الثابتة التي تعرض بسرعة بحيث يكون الزمن بين عرض الصورة، والتالية أقل من مدة الاحتفاظ بها في الذاكرة الحسية؛ وبالتالي نرى الصورة التالية كما لو كانت متحركة من وضع الصورة الأولى.
2- نظام الذاكرة ذو الأجل القصير:
ولكي يتم إرسال المعلومات الحسية إلى هذا النظام من الذاكرة على الشخص أن ينتبه إلى المعلومات لوقت قصير، حينئذ تمر المعلومات إلى ذاكرة الأجل القصير الذي كثيراً ما نتصوره بأنه مركز الوعي. ويقوم هذا المخزن بالحفاظ على كمية محدودة من المعلومات لمدة مؤقتة "عادة لمدة 15 ثانية"، ويمكن الاحتفاظ بالمعلومات في هذا النظام لمدة أطول بالتكرار أو التسميع.
وبالإضافة لعملية الخزن فإن هذا النظام يعمل كمركز تنفيذي في دخول وخروج المعلومات من نظام آخر للذاكرة، هو الذاكرة ذات الأجل الطويل، وأفضل مثال لتوضيح هذا النوع من الذاكرة هو استخدامك لدليل التليفون للاتصال بشخص لأول مرة، وحفظ رقمه في الذاكرة قصيرة الأجل لاستخدامه أثناء إدارة القرص، وبعد الاتصال لو سئلت عن رقم التليفون لا يمكنك تذكره، ولكن إذا كان هذا الرقم له دلالة معينة أو تعاملت معه بطريقة أكثر عمقاً فإنه ينتقل إلى ذاكرة الأجل الطويل.
3- نظام الذاكرة ذو الأجل الطويل:
ويحدث هذا النوع من التخزين عندما تعالج العمليات الموجودة في التخزين الحسي، والتخزين قصير الأجل بعمق لأجل تذكرها لفترة تزيد عن 30 ثانية، وقد تصل إلى 30 عاماً. ولكي يتم هذا التعامل العميق يلجأ الأفراد إلى وسائل حفظ متقدمة، فيفهمون أكثر، ويفكرون في معنى ما سمعوه، ويربطون بين المعلومات وبين الأفكار الموجودة فعلاً في ذاكرة المدى الطويل. ولكن في بعض الحالات يكفي التكرار البسيط للمعلومات لتنتقل إلى ذاكرة الأجل الطويل.
وتعدّ الذاكرة طويل الأجل أهم نظام في نظم الذاكرة الثلاث وأكثرها تعقيداً، حيث أن إمكانية الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة الأجل محدودة للغاية، فالنظام الأول زمن احتفاظه أجزاء من الثانية، والنظام الثاني لا يستطيع تخزين أكثر من عدة عناصر لا تزيد في أغلب الأحيان عن عشرة عناصر أياً كان نوع هذه العناصر، بينما الذاكرة طويلة الأجل تتميز بأن طاقتها وإمكاناتها غير محدودة من حيث كمية المعلومات أو زمن الاحتفاظ بها. فكل المعلومات التي تبقى في الذاكرة أكثر من دقائق معدودة بالإضافة إلى الخبرات السابقة تدخل في نطاق نظام الذاكرة طويلة الأجل. ومن خصائص هذا النظام أن فيه يتم توضيح المعلومات أثناء تخزينها بطريقة تيسر استرجاعها في الموقف المناسب.
ثالثاً: مرحلة الاسترجاع:
تتضمن هذه المرحلة عملية البحث عن العلميات المرغوبة في مخزن الذاكرة وإظهارها في شكل استجابات ذاكرية. إذا كانت المعلومات في الذاكرة الحسية فإن الانتباه إليها أو فهم معناها يؤدي بها إلى الانتقال أوتوماتيكياً إلى مخزن الأجل القصير، ويسمي علماء النفس هذا النوع من الانتقال "الاسترجاع من الذاكرة الحسية". وإذا كانت المعلومات موجودة حالياً في ذاكرة الأجل القصير، أو الوعي فإن العثور على المعلومات لا يستغرق وقتاً، فالمعلومات المزنة يتم سحبها بسرعة وكفاءة.
أما إذا كانت المعلومات المطلوب استرجاعها في الذاكرة طويلة الأجل وهو الشيء المعتاد؛ فإن عملية الاسترجاع تكون أحياناً سهلة وآلية، مثل تذكر الاسم، أو السن أو العنوان، لكن في بعض الأحيان يكون استرجاع الذكريات البعيدة أمراً شاقاً وقد يظهر أحياناً حالة تسمى "على طرف اللسان" وهي الحالة التي منها لا يستطيع الشخص تذكر كلمة "مثل اسم شخص" مع أنه متأكد تماماً أنه يعرفه، وأنه على وشط تذكر اسمه وقد يذكر منه حرف أو بعض الحروف. وعملية استرجاع الخبرات الماضية من الذاكرة طويلة الأجل تمر بعدة عمليات جزئية، هي: عملية البحث عن المعلومات المرغوب فيها في مخزن الذاكرة، وتعيش موقعها في هذا المخزن، وعملية تجميع هذه المعلومات وتنظيمها، وإعدادها في الذاكـرة
قصيرة الأجل، أو الوعي ثم عملية آدائها على شكل استجابات ذاكرية.
معينات تحسين الذاكرة:
على الرغم من الأهمية الكبيرة للذاكرة وفائدتها للإنسان إلا أنها قريبة الشبه بالذكاء في عدم إمكانية تنميتها بالتدريب أو غيره إلا في حدود ضيقة لا تكاد تذكر. ولكن إذا كان من الصعب تنميتها إلا أنه يمكن تقديم بعض النصائح التي تعين أو تساعد على التذكر وتقاوم النسيان. ولا شك أن الطالب أكثر الناس حاجة لاستخدام هذه المعينات في تعلم دروسه:
1- إن تنظيم المادة المراد تعلمها والربط بينها وبين غيرها من المواد المتصلة بها وجعلها في شكل متسق يساعد على الاحتفاظ بها لفترات طويلة، كما يساعد على تذكرها عند اللزوم.
2- ضرورة بذل الجهد في فهم المادة المراد حفظها، لأن الفهم يجعل المادة تقاوم النسيان وتحتفظ بها الذاكرة لفترات طويلة.
3- ضرورة أن يأخذ الطالب فترة راحة بين تعلم أو استذكار مادة وأخرى؛ حيث تثبت المادة السابقة ولا تتداخل مع المادة اللاحقة.
4- ضرورة مراجعة المادة المتعلمة بين الحين والآخر، حتى لا تتلاشى من الذاكرة وتنسى.
5- التركيز أثناء الاستذكار والبعد عن المثيرات التي تشتت الانتباه.
6- حاول أن تلخص المادة المراد استيعابها كتابة، لكي تتأكد من فهم المادة، ومعرفة الأجزاء التي لم تحصلها جيداً فتركز عليها.
7- اجعل جزءاً من الوقت الذي تقضيه في التحصيل مخصصاً لتسميع ما حفظته أو تعلمته.
8- يفضل إلقاء نظرة عامة وشاملة من البداية على التخطيط العام لموضوعات فصول الكتاب ثم العناوين الرئيسية ثم العناوين الفرعية؛ لأن هذا يؤدي إلى إحداث نوع من التكامل بين هذه المادة يساعد على سرعة حفظها واسترجاعها.