مساحة إعلانية
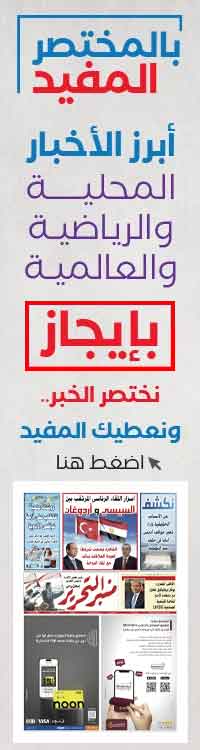

ثلاثون عاماً بين تاريخي وفاة أولهما وثانيهما، لكنها لم تكن كافية لتعلَمَ الأجيال التالية أن الذي حَمَلَ الاسم [ إسماعيل صبري ] في مصر لم يكن شاعراً واحداً، بل شاعران!! - اشتركا في الاسم، واختلفا في اللقب.
أما الأول فهو الشاعر المعروف إسماعيل صبري (باشا) القاضي ورجل القانون الذي يعدّ في الطليعة من رواد الشعر المصري، وقد وُلد سنة 1854 وتوفي سنة 1923م..
وأما الثاني فهو إسماعيل صبري (أفندي) وكان موظفاً صغيراً في وزارة المعارف، إذ لم يحصل من التعليم قسطاً كبيراً، فلم يتجاوز الشهادة الثانوية، وقد وُلد سنة 1886م وتوفي سنة 1953م.
وكان لقب (باشا) في مصر -آنذاك- لا يناله إلا كبار الأغنياء أو أصحاب المناصب الرفيعة التي تعادل درجة الوزير. أما لقب (أفندي) فكان يُطلق على صغار الموظفين، أو الخريجين الجُدد من الجامعات، فإذا ارتقوا في وظائفهم نالوا - بشروطٍ معينة- "البكوية" وهي لقب (بك) الذي ينطقه العامة (بيه).
وبين حالي شاعرينا اختلاف كبير، فالأول من عليّة القوم، درسَ القانون في فرنسا، ثم عمِل في سلك القضاء .. قاضياً فنائباً عاماً، ثم تولّى منصب محافظ الإسكندرية، وانتهى به العمل الحكومي وكيلاً لوزارة العدل (وكانت تسمى نظارة الحقانية آنذاك)، وكان على إجادته الشعر، قليل الاعتداد بنشر شعره، أو جمعه، فلم يسعَ لنشر قصائده أو ديوانه، بل تولّى ذلك أصدقاؤه بعد وفاته.
ومن مواقفه الوطنية الخالدة، أنه -وهو وكيل لوزارة العدل- رفض مقابلة المندوب السامي البريطاني اللورد كرومر، وقـد قِـيل له وقتها: "إن اللورد كرومر يريد الاجتماع بك تمهيداً لاختيارك رئيساً لمجلس الوزراء" فقال إسماعيل صبري: "لن أكون رئيساً للوزراء وأخسر ضميري". وكان من مفاخر القضاة آنذاك الحفاظ على هيبة القضاء ونزاهته، والتباهي بأن "ضمير" القاضي شيء عظيم لا يُباع ولا يُشترى.!
ومن أشهر قصائد إسماعيل صبري (باشا) نونيته التي مطلعها:
لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني ...إذا وَنَى يَـوم تحصيل العُـلا وانِ
وفيها يصف أهرام مصر فيقول:
أهرامُهُـم تِـلك، حيِّ الفنّ متخذاً .. من الصخُور بروجاً فوق كِيوانِ
قد مرّ دهرٌ عليها وهي ساخِـرةٌ .. بما يُضَـعْضَع من صرحٍ وإيوانِ
لم يأخذ الليل منها والنهـار سوى .. ما يأخذ النمل من أركان ثهْـلانِ
كأنها -والعوادي في جَـوانِبِـهَا .. صرعى- بناء شياطِينٍ لشَـيْطانِ
جاءت إليها وفودُ الأرضِ قاطِـبةً .. تسعى اشتياقاً إلى ما خلَّد الفانِـي
وعلى الرغم مما في شعر إسماعيل صبري باشا من قوة وإجادة، فإنه –كما قلنا- كان عزُوفاً عن نشر شعره، أو جمعه في ديوان، ولولا أن أصدقاءه كانوا يعرفون فيه هذه العادة، لضاع أكثر شعره.
وقد قام صهره القاضي حسن رفعت بك بجمع شعره بعد وفاته،وكتب للديوان مقدمة موجزة حكى فيها قصة أول لقاء جمعه بالشاعر الرائد اسماعيل صبري باشا ، وتحدث عن ظاهرة إهماله نشر شعره أو المحافظة عليه من الضياع وكان مما قال :
" وقد أخبرني الأستاذ الكبير المأسوف عليه داود بركات رئيس تحرير جريدة الأهرام أن إسماعيل صبري الذي كان يقدّره ويأنس به، قرأ عليه يوماً نشيداً قومياً من أبدع ما جادت به قريحته، فرغب إليه أن يتركه عنده ليحلّيَ به صدرَ صحيفته، غير أن صبرياً طلب إليه التريث إلى الغد، ثم أخبره بعد ذلك أشد الأسف، وعوّل على ألا يترك صبري إذا أسمعه قصيدة من نظمه حتى يأخذها.
ولما عرفتُ هذه العادة فيه، خِفتُ على آثاره الثمينة من التشتت والضياع؛ فعقدتُ النية على جمع ما تفرق منها في بُطونِ الكتب وثنايا الصحف والمجلات، وما حفظه أصدقاؤه والرواة من قَطَعِهِ التي لم تُنشَر، والحرص على ما يجدّ منها.
وحين فُجع الأدب العربي بوفاته في أوائل عام 1923، كان أكثر ما أثمرته عبقريته بعد اتصالي به محفوظاً لديّ، ولم تُتِح لي الظروف قبل وفاته إنجاز ما كنت قد اعتزمت في شأن ما انطوى عليه الماضي البعيد من آثاره الجليلة؛ فشمرتُ عن ساعد الجِد، وبذلت أقصى الجَهد في إخراجه من مكامنه، وعاونني في ذلك ولداي الدكتور إبراهيم رفعت المدرس بكلية الهندسة، وأحمد رفعت المهندس، وصديقنا عبدالحميد أحمد ثابت المدرس بالمدارس الأميرية وغيرهم، ولا يخفَى ما يتطلبه مثل هذا البحث من الزمن الطويل والجهد الشاق.
ولما أن تمّ لي ما أردت من جمعِ هذا التراث الغالي تفضّل العلامة الأستاذ أحمد الزين، صديق صبري وجليسه، بتنسيق ديوانه وتشكيله، وشرحه على أكمل وجه، وتولت لجنة التأليف والترجمة والنشر إخراجه."
أمّا سميّه الشاعر إسماعيل صبري (أفندي) فقد عنيت بنشر ديوانه إدارة إحياء التراث التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وعهدت إلى ثلاثة من الأساتذة : - هم الشاعر/ عامر بحيري، والدكتور محمد القصّاص، والدكتور أحمد كمال زكي – بجمع تراث هذا الشاعر المغمور، ثم أخرجته في ديوان كبير بتقديم وافٍ كتبه الشاعر عامر بحيري وكان مما قال فيه:
"استنّت إدارة إحياء التراث بوزارة الثقافة والإرشاد القومي، سُنة طيبة في العمل على تحقيق ونشر دواوين الشعراء المحدثين، بين ما تحققه وتنشره من كتب التراث الأخرى، قديمها وحديثها، يستوي في ذلك عندها الشعراء الذين تألقت حظوظُهم، وازدهرت أسماؤهم، في حياتهم وبعد مماتهم، من أمثال البارودي وصبري وشوقي وحافظ ومحرم ونسيم وغيرهم، وإخوانهم الشعراء الآخرون الذين لم يواتهم من الحظوظ، ولا من بُعد الصيت ما واتى أندادهم الأولين.
وأشار عامر بحيري في التقديم إلى أن اسماعيل أفندي صبري خُلَقَ فنّاناً موهوباً في ضُروبٍ عدّة، فهو يحسن الخط العربي إلى درجة الإتقان، وهو يجيد الرسم إلى مرتبة جعلته يختص بتدريس مادة الرسم في مدارس الوزارة مُبرزاً في فنه، وهو ينظم الشعر عاطفياً ملهماً، قويّ الديباجة، سليم اللغة، جيّاشاَ بنوازعِ النفس، حتى إن شعره لتختار منه المقطوعات المناسبة، يلحنها الملحنُون، ويغنيها المغنُون، من أبناء جيله .. ويحفظها عن طريق تسجيلها على اسطوانات الحاكي –وهو وسيلة نشر الغناء الكبرى يومئذ- كثيرون من أبناء الجيل .. وهذا هو الباب الذي نفذَ مِنه شاعرنا إلى مجتمعه، رغم القيود والسدود لكي يحصل على لقمة العيش من ناحية، ولكي يشغل مكاناً موهوباً في الوسط الفني من ناحية أخرى".
وطوال هذا التقديم، آثر الشاعر عامر بحيري أن يلقّب إسماعيل صبري باشا "بالكبير" وإسماعيل صبري أفندي "بالصغير". وأغلب الظن أنه عني بالكبر هنا التقدم في السن، والمركز الاجتماعي والمستوى الفني، فكل ذلك واضح في تقديمه الذي يبدو منه أن إسماعيل صبري (أفندي) أو الصغير –كما شاء عامر بحيري أن يلقبه- قد بدأ نشر قصائده مبكراً في الصحُفِ منذ السنوات العشر الأول من القرن العشرين.
وقد وضحَ من تقديم الشاعر عامر بحيري للديوان أن اللجنة الثلاثية التي كُلِّفَتْ جمْعَ هذا الديوان من مظانّه، عانت كثيراً خلال عملها، فإن بعض ما ترك إسماعيل صبري (أفندي) من أوراق لم يكن منقحاً في صورته النهائية، فكان يوجد البيت والبيتان من الشعر القديم مضمنين في مخطوطة قصيدة له دون تنصيص هكذا "......." مما شكّك مقدم الديوان في أن شاعرنا إما أنه ينتحل لنفسه بعض ما يستجيده من أبيات الشعراء القدماء كالبحتري والمتنبي، أو أن محفوظه من الشعر القديم كان غزيراً وفيراً بحيث يطغى على ما ينظمه فتتسرب الأبيات المحفوظة بين أبياته المنظومة دون وعي أو انتباه إلى ذلك.
وقد أشار بحيري إلى أن للشاعر ملحمتين مطوّلتين ضمهما جامعو الديوان فيه، وهما ملحمتان طويلتا النفس إذ تقع أولاهما في نحو ألف بيت، والثانية في نحو ستمائة بيت استعرض الشاعر فيهما أحوال البشرية وتاريخها وأخبارها، فالملحمة الأولى (الكبرى) نونية مطلعها:
ربِّ هَبْ لِي هُـدًى وأَطْلِقْ لِسَانِي وَأَنـِرْ خَاطِرِي وَثَـبِّتْ جَـنَانِـي
بدأها الشاعر بنظم أسماء الله الحسنى، ثم تحدث عن البعث والنشور وما فيهما من حكمةٍ، وعن أهوالِ القيامة وأهوالها من جنة ونار، وما ينتظر الإنسان من مصير، ثم تحدث عن مخلوقات الله المتنوعة ومنها تطرق إلى الإسلام وتاريخه.
وسار على النهج نفسه في ملحمته الثانية الهمزية ومطلعها:
أَيُّـهَا الْنَّـاسُ أَنْـتُمُ الْفُـقَـرَاءُ فَاذْكُـرُوا مَنْ لَهُ الْغِـنَى وَالبَقَاءُ
وهكذا فإن الشاعرين اشتركا في الاسم، واشتركا في صفة أخرى وهي أن كليهما أهمل جمع شعره، وجمعه من جاءوا بعده، ولكنهما اختلفا في درجة الإجادة، كما اختلفا في اللقب وما ارتبط به من مكانةٍ اجتماعيةٍ.